فـي نهاية مقالتي السابقة «الأدب والدواء» (1 - 1 - 2025)، قلت إن علينا «أن نسأل اللغة. علينا أن نواجه أنفسنا بالنصوص وبالآخرين». هنا، يبدو المعنى الحقيقي للأدب أي أن عملية فك الرموز هو ما يفعله كل قارئ طالما أنه فضولي. وتوضيح الطريق، هو ما يفعله كل كاتب، وهكذا فإن الكلمات، التي تردد بعضها البعض، تتحدث عن عملية مرايا، إن الفجوة الثقافـية بين العلم والأدب ما هي إلا راحة للعقل تسبب الكثير من المضايقات، وفـي الحضارة إزعاجًا ملموسًا. فك رموز النص ليس بهذه البساطة كما يبدو. للحصول على فكرة عنه، علينا أن ننخرط فـي هذا التمرين لفترة طويلة، وأن لا نبقى خارج النص بل أن نسمح لأنفسنا بالتشبع به من أجل اختراقه. بعبارة أخرى، بعد أن اختبرناه بعقول غير مقيدة، ما علاقة هذا العمل بالعناية؟
وهنا أيضا ينبغي أن نُفرد السؤال. علينا أن نحاول أن نقترح. أن نقول. أن نفتح مساحة، فـي ما أفعله من ثقافة - ثقافتي- مجزأة مثل ممرّ السوبر ماركت، وهي ثقافة تبدو أحيانًا وكأنها فـي حالة تراجع. لكن الأدب هو أيضا «مثل طائر الفـينيق»: إنه لا يتوقف عن الولادة من رماده من جديد منذ فجر البشرية. ويحدث ذلك تحت الأرض، عندما يحد المجتمع من إمكانية سماعه. ثم يصبح غاضبًا، وأكثر تخريبًا من أي وقت مضى، وأكثر خطورة، وأكثر إضاءة. يتم تداوله بالخفاء. لذا أرغب فـي نشر هذه الكلمات. فـي تمزيقها بعيدا. فـي كتابتها، فـي قراءتها ولو سرا على ضوء الشموع. كلمات أرغب فـي أن تعبر حدود الكتاب المسجونة فـي داخله. ما هي هذه الحاجة الحيوية للقراءة والكتابة، التي تستهزئ بها كل القوى العاجزة عن تدجينها والممتدة عبر القرون؟
لنعد إلى مفهوم العناية هذا (الذي طرحته فـي مقالة «الأدب والعلاج، بتاريخ 18 - 12 - 2024)، وهو مفهوم أساسي فـي الطب. قد يكون الشفاء هو هدف كل إنسان يعمل بالفن. لكن هذا الفن، حتى لو رغب فـي ذلك، لا يستطيع أن يفعل كل شيء. يواجه الطبيب حدودًا كل يوم. معرفته نفسها تواجه حدودا. فحقيقته - المؤقتة إن كانت علمية - ليست حقيقة المريض. إن معالجة الجسد المتألم لا تعني معالجة الذاتية التي تتغلغل فـي هذا الجسد الضعيف الذي ينزلق فجأة.
ماذا لو كانت حقيقة المريض أكثر أبدية من حقيقة العلوم الاختزالية التي أسست الطب الحيوي؟ ربما من شأن التحول الثقافـي أن يفتح العديد من الأبواب. لم أصل إلى هناك بعد. العقائد المعاصرة لها كلمتها. بدلاً من فك رموز اللغز، بدلاً من دعم كل شخص واحدا تلو الآخر فـي عملية فك الرموز الحيوية هذه، نقوم بتشفـيرها. لأننا نحسب كل شيء، لأننا عشوائيون. وهذا النهج مفـيد، فـي بعض النواحي، وتبرز إلى السطح حقائق جماعية ظلت من دون أن يلاحظها أحد. وما زلنا بحاجة إلى فهم حدوده. كيفـية تفسير النتائج؟ بمَ تتعلق؟ الطب المبني على الأدلة، اليوم، لا يدعم نفسه إلا من خلال عدم التشكيك فـي الإطار الثقافـي الذي يقع فـيه ونموذج الأدلة المحتفظ بها. كل فكرة تتناسب مع الإطار. إن عدم التفكير فـي الإطار هو تعريض النفس لكل التجاوزات التي يعرفها التاريخ جيداً. لقد خدم العلم أيضًا أسبابًا لا توصف، ولا ينبغي لأي طبيب أن ينسى ذلك أبدًا. فالعلم من دون ذاكرة هو مجرد عقيدة مثل أي عقيدة أخرى، وخطيرة مثل أي عقيدة أخرى. والوعي من دون ذاكرة هو مجرد قوقعة فارغة. وحده الأدب، الذي ليس خطابًا، بل ذكرى وخلق، هو الذي يسمح بانتهاك العقائد. فـي بعض الأحيان إلى الأسوأ، ولكن فـي بعض الأحيان أيضا إلى الأفضل.
الأدب، هو أمّ كلّ العلوم الإنسانية، هو المكان الذي يتمّ فـيه التعبير عن جميع الحقائق، وجميع المعتقدات، وجميع الأكاذيب فـي العالم ونقلها. تعلن الإنسانية فـيه بموهبة أكثر أو أقل عن شكواها، وضيقها، ورغباتها، وأوهامها، وانزياحاتها، وآمالها، واكتشافاتها. إن النص، بصفته مرآة، هو أيضًا مكان للقاء واكتشاف الآخر والنفس، كل واحد محفور فـي وقته ويرتبط، بطريقته الخاصة، ببعد من العالمية. نجد أنفسنا فـيه، مثلما تقول الفطرة السليمة. نحن نتعرف على أنفسنا فـي داخله. ولكننا أيضًا نفرد جناحينا فـيه، مثل الفراشة التي تخرج من شرنقتها، نكتشف أنفسنا... أحيانًا نكون أقل وحدة مما كنا نعتقد، مهما كنا فريدين. افترض فرويد أن الإبداع الأدبي يخفف التوترات العميقة. لكنه اختزل الإبداع الأدبي فـي التعبير عن الأوهام فـي شكل جمالي مُرضٍ، وهو ما يؤدي إلى التقليل من قيمة جزء كبير من الأدب الإبداعي الذي كان هو نفسه جزءًا منه. لا يمكن اختزال الإبداع الأدبي فـي حلم اليقظة، حتى لو كان مرتبطا دائما باللاوعي. إذا كان الأدب يأخذ مصادره من «جسد» (والذي يبدأ حتى قبل ولادته بكونه «جسما»)، فهو أيضًا تعبير عن علاقة واعية (أو لا) لهذا «الجسد» مع عالم عصره، مع النصوص، وخاصة مع لغة عصره. وهذه أيضًا هي الطريقة التي يجد بها القراء أنفسهم هناك ويجدون الغذاء هناك. من ناحية، يعمل الأدب مثل نزل إسباني، حيث يقرأ معظمهم فقط ما يعرضونه هناك ويستمدون المتعة منه، ومن ناحية أخرى، يعمل الأدب كنافذة مفتوحة على الآخر، على العالم وعلى الذات. إذا كان الصوت الذي يتحدث فـي النص يتحدث إلى قلبك وجسدك، فـيمكن أن تصبح القراءة فـي بعض الأحيان تجربة داخلية ويمكن أن يتغير شيء ما فـي الحياة. وفـي هذا الصدد بالفعل، يعد الأدب علاجًا، لأنه يخلق روابط بين الكائنات ويغير حياة الآلاف، بل الملايين. فهو يسمح للمشلول بالسفر، وللأعمى أن يرى عوالم مجهولة، وللأصم أن يسمع أصوات البشر وهم يتحدثون مع بعضهم البعض وإليه. الأدب عبارة عن خيال وواقع حساس منسوج بإحكام، بحيث يمكن للقارئ، الذي تهدهده لغة تحييه، أن يبدأ فـي الحلم مرة أخرى، فـي التفكير، وأن يولد من جديد لنفسه وللعالم. المرض الذي يواجه الجسم الآلي الذي لم يعد يعمل، يغرق فـي الظلام. فـي مواجهة هذا الظلام المهدد، يعيد الأدب تنشيط تروس هذه الآلة الفاشلة بالنفس والرغبة والمعنى، وربما يعيد ربط الجميع بإبداعهم الفريد، الذي يتم خنقه أحيانًا لفترة طويلة. لماذا لا تكون لهذا الإبداع المتجدد تأثيرات عضوية؟ فـي أي حال، حتى النهاية، وطالما أمكن إبعاد الألم، يظل الأدب شعلة ترتعش فـي الليل وتربط المريض، وقد اختزله الطب الحيوي إلى جسد مشبوه، واستُبعد بوحشية من العالم من خلال هذه التجربة الحميمة التي تعزله وترعبه فـي مجتمع الأحياء. هل هذا صحيح؟ ننسى شيئا أساسيا: الكتابة أيضا تفرض «أمراضها» على الكاتب، تفرض عليه انسحابا من واقع، ليعيش مع كلماته التي يخطها. تفرض عليه عزلتها هي، لا عزلته هو. الكاتب ليس معزولا حين يجلس بين كتبه المليئة بملايين الشخصيات والأحداث التي يحاورها باستمرار. لكن منطق الأشياء يفترض أن يبتعد عن كلّ شيء، ليستقدم الوافدين الجدد، الذين لا يعرفهم، ويحاول أن يفهم شيئا عنهم، يحاول أن يتآلف معهم على أقل تقدير.








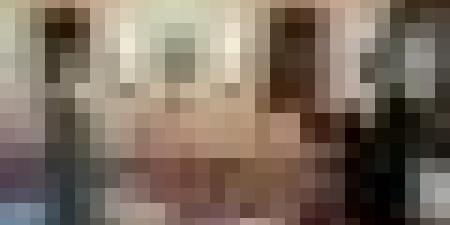
0 تعليق