تحل العلاقة التشابكية – وفق المعنى الذي يشير إليه العنوان - عبر ثلاثية أبعاد الصورة الذهنية، وهي الصورة التي تستحوذ على كثير من مساحة مخيلتنا التي تجبرنا في كثير من الأحيان على رسم الصور عن الآخر، وعلى اتخاذ قرار بقاء هذه الصور وعدم تزحزحها عنه، مهما كان مستوى التغير كبيرا وواسعا، وهذه الأبعاد مؤلفة من: الصور النمطية التي يرسمها الأفراد لأقرانهم، أو لمؤسسات، أو لدول، أو لمجموعات، أو لمفاهيم عامة في الحياة اليومية.
كما تشمل الحتميات التي يؤمن بها هؤلاء الأفراد أنفسهم، ويسقطوها على ذات الصور أعلاه فتصبح مسلمات لديهم، ولن يقبلوا نقاشا يفضي إلى إرباك هذه الحتميات التي آمنوا بها.
وللإيمان «المتأرجح» بعلاقات الثابت والمتغير وهو ذاته ما يذهب إليه هؤلاء الأفراد في حياتهم اليومية، ويؤمنون به إيمانا قطعيا في شؤون حياتهم في جوانب أخرى مختلفة، ولذلك تسمع منهم جملة: «صحيح، ولكن» وفي «لكنهم» وهنا تتموضع المشكلة.
ومن خلال هذه الأبعاد تقع الصورة الذهنية في إشكالية موضوعية في التعامل مع كل هذه الصور، أو التموضعات سمّها ما شئت.
فهل هناك منا من لا يوصف فرد ما بأوصاف قاتلة، بخيل أحمق، فوضوي، شبه مجنون، منافق – وهذه أكثر الأوصاف – هذا ناكر الجميل، هذا متسلط، هذا جبار، هذا صعب التعامل معه، ونظل على قناعاتنا التي نؤكدها على هؤلاء من نصفهم بذلك حينا من الدهر، مع تغيرهم المحتمل في أي لحظة زمنية ممكنة، حتى تتحول هذه الصور النمطية التي رسمناها عن هؤلاء جميعهم عندنا إلى حتميات لا يمكن أن تتغير، ولذلك نترقب أي فعل صغير يقوم به هؤلاء ما يؤصل القناعة «الحتمية» لدينا، ونضل على ذلك آمنين بقناعاتنا، وتجدنا في كل مجلس نردد: ألم أقل لكم .. فلان لن يتغير، بينما الحقيقة نحن لم نتغير وليس فلانا، بتأصيل موقفنا هذه أو نظرتنا هذه تجاه فلان من الناس، وتأتي اللحظة الزمنية الفارقة، حيث فعل «الثابت، إلى متغير» لينسف كل القناعات التي آمنا بها قبل هذه اللحظة، فماذا نقول؟ «سبحان الله مغيّر الأحوال» ومع قولنا بذلك، إلا أن القناعات المتأصلة والتي استمرت ردحا من الزمن لا تزال تلعب بالمخيلة الذهنية، فتربكها بين هذين الفعلين المتناقضين في ذاكرتنا، وليس في حركة الحياة التي يعيشها هذا الآخر، الذي بدأ في مسار التغيير، سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، فالمهم أن هناك تغييرا.
الفكرة تبحث أكثر في مسألة التضاد بين هذه المواقف؛ لأن الإشكالية هنا هو تأصيل القناعات عندنا، وهي قناعات عندما تصل إلى مستوى معين من الثبات، لن يكون الأمر يسيرا في خضوعها لعمليات «المتغير» حيث يتم نقلها إلى الثابت، مع أن الحياة برمتها متغيرة في كل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، ولأن الأمر كذلك، فلماذا الإنسان – مع أنه الفاعل الحقيقي في التغيير – لا يتزحزح عن قناعاته عن الآخرين من حوله، ويظل مصرا على تأصيل الصور النمطية، ويلحقها بحتميات مجموعة القناعات التي يؤمن بها، ألا يرى هؤلاء هذا اليوم الذي يعيشونه بدءا من مشرق الشمس، وانتهاء بمغربها؟ وفي هذه الفترة الزمنية المتنوعة بين حر، حيث أشعة الشمس تقترب من الرؤوس، وبين برد حيث تغادر الشمس بعيدا، كم من الأحداث التي تقع، وكم من المواقف التي تتغير، وكم من القناعات التي تتبدل، وكم من المآسي التي تقع، وكم من الآفاق الآمنة أيضا ترفرف على سماوات الكثيرين من الناس، وكم من الناس الذين يرتفعون سلم المجد، وكم من آخرين تنزلهم الحياة إلى أسفل السافلين، وبالتالي، ووفق هذه الصور المتدافعة والمتجلية على امتداد الأفق، كيف للصور النمطية التي يرسمها الناس عن كل شيء، يمكنها أن تبقى؟ وكيف للحتميات أن تظل صلبة لا يمكن اختراقها وتغيير مساراتها، وتفاعلاتها؟ وكيف لا تتهلل الأنفس الأخرى بحالات المتغير، وهي تركل الثابت المعيق، وتستبدله بالمتغير الحاضن للحياة والأمل والتفاؤل؟ وتربك الحتميات في تجلدها، وتستبدلها بوجوه جديدة، ما كان للمخيلة أن تستحضرها في ظل قناعاتها المتجمدة.
هل في هذه الصور بتجلياتها أو تموضعاتها المختلفة، شيء من الفلسفة غير الواضحة، أو غير المدركة من قبل الجميع؟ شخصيا: لا أتصور ذلك على الإطلاق، وما يظهر لي، أن هناك أمراضا نفسية، أو عقدا نفسية، سمّها ما شئت هي التي تحول دون وضوح الرؤية عند الكثيرين الذين يناصرون ذواتهم بثوابت الصور النمطية عن كثير مما يدور حولهم، وعن تأصيل الحتميات التي تحيطهم، أو يحيطون أنفسهم بها، وألّا أمل في اختراقها، وهم الذي يرون أن عمليات الثابت والمتغير هو نوع من الجدل السفسطائي الذي لا قيمة له، بينما الحياة ثابتة – وفق رؤيتهم - ولا تقبل التغيير، وأن اللحظات الزمنية الفارقة التي تنشئ الأحداث والمواقف، وتربك ثباتها، وتغير وجه الحياة، هي حالات استثنائية غير قابلة للبقاء والحكم على ديمومتها، وجل هؤلاء هم المتشبثون بالمنطق، بينما المنطق في حد ذاته، يؤصل معنى التغيير، ويرى في الثبات أمرا مغايرا لحقيقته كمنطق، فالإنسان الذي يولد عاجزا حتى عن خدمة نفسه، هو نفسه، كتكوين بيولوجي، من سوف يحكم جزءا من العالم، وعالمه هذا الذي يحكمه حينا من الدهر، ينتظر منه شيئا من اليسر، وقد يبدي الكثير من العسر، وما بين مرحلتي الولادة والنهاية علينا أن نحصي عددا: الصور النمطية التي يوصف بها، وعددا من الحتميات التي تحيط به، فتلبسه الكثير من المناعة وعددا من حالات التغير التي تحدث له، وليتصور أحدنا كم من الملفات التي سوف تتراكم لاحتساب ذلك كله، وهذا الأمر لن يكون مقصورا عن الأهمية التي يكون عليها أي فرد ظهر على سطح هذه الحياة، هنا أو هناك، بل كل فرد يمكن القياس عليه، وليس هناك فرد يعيش على الهامش، كما يتم وصف بعض الأشخاص بذلك، بمعنى أنه لا يوجد فرد ولد مع إشراقة يوم من أيام الله، لن يلعب دورا محوريا على مستوى من حوله، حتى أولئك المشردون الذين يعيشون على الأرصفة، وتركلهم الأرجل، وتقذفهم الألسن، وتغض الأعين الطرف عنهم، هم يشكلون أهمية ما في ذات المساحة التي يفترشونها، والدليل أن هناك أنفسا تحن عليهم، ومتى أحنت عليهم، معنى ذلك اتخذت مساحة وجدانية في نفوسهم، فارتبكت الصورة النمطية على أنه مشرد، لا قيمة له، إلى إنسان يجب أن يعيش، وأن ينظر إليه بعين الرحمة والعطف، وفي هذا التغير البسيط الذي يتكون في لحظة زمنية فارقة، تلتغي كل الحتميات المرسومة عن صلف الإنسان وجبروته، وتجفيف مشاعره.
هناك أناس كثيرون، ولعلني واحد منهم، يضعون مساحة أفقية بينهم وبين الآخرين من حولهم، في هذه المساحة يتنفسون عطر حريتهم، فلا يوقعون أنفسهم في مأزق رسم الصور النمطية عن الآخرين من حولهم: هذا بخيل، هذا أحمق، هذا فوضوي، هذا شبه مجنون، هذا منافق، هذا ناكر الجميل، هذا متسلط، هذا جبار، هذا صعب التعامل معه، يحدث هذا لإدراك الذي تؤمن به الذات أن لا ثبات في حياة أي إنسان، وبالتالي يظل من الحمق رسم صور نمطية عنه، وإلحاق هذه الصور بالقناعات الذاتية لتصل إلى حتمية التغيير؛ لأن الأصل هو المتغير، وليس الثابت، ومن يؤمن بالثابت على حساب المتغير، فقد أوقع نفسه في مأزق ظلم الآخر، طبعا هذا الأمر لا يمكن إغفال فيه أمرا مهما، وهو مجموعة الظروف المحيطة بهذا الشخص أو ذاك، وأثر ذلك على ديمومة الحالة التي يكون عليها، ولكن عند النظر إليه كإنسان، له مشاعر، وطموحات، وآمال، وتوقعات، ورؤى استشرافية، فهذا كله من شأنه أن يتجاوز الحالة المؤقتة في بقائه على نمط واحد لحياته، أو سلوكه، أو مواقفه، أو قراراته، ويكفي معاتبته لنفسه في لحظات الضعف، أن يحسب له ذلك على أنه تغير كبير، ينقله من حالة العسر، إلى حالة اليسر، وهذا أمر مهم.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني








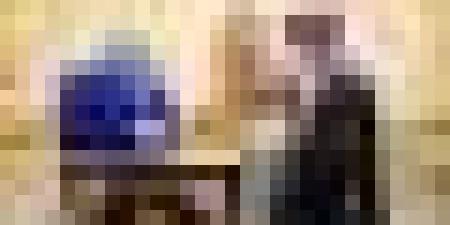



0 تعليق