د. يوسف مكي
في مقال سابق، حمل عنوان «المواطنة بين الأيديولوجيا والرؤية المدنية للدولة»، ختمنا برؤية الدكتور محمد عابد الجابري، حول المنطق السياسي للجماعة الدينية، حيث أشار بأنه في الأغلب لا يتأسس على مقاييس معرفية، بل على رموز مخيالية. إن المواقف والرؤى تتم بمعزل عن كل استدلال.
المعضلة أن هذا النوع من الجماعات، لا يرتبط بالواقع الاقتصادي الاجتماعي. إنها أسيرة تاريخ مختلف تماماً، عن الواقع الراهن، وهي تمثل لرؤى رومانسية، منقولة من الماضي إلى الحاضر. إن الأساس الجامع لها، هو غربتها التاريخية. وهي بديماغوجيتها، لا تحتكم للوعي. كما أنها جزء من بنية كلية، يصعب التفريق فيها بين ما هو أساسي وما هو جوهري. والنتيجة أن معاركها وصراعاتها، لا تكون بالضرورة انعكاساً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه، بل هي على الأعم، محاكاة لصراعات قديمة تجد أسسها في الماضي وليس بالواقع الراهن.
أول ما يواجهنا عند تفكيك بنية هذه الجماعات، حلول فكرة الهجرة المستمرة، بديلاً عن الانتماء للوطن. وما دامت الرسالة أممية، فالوطن معدوم. وتجد هذه الرؤية جذورها فيما قبل نشوء الدولة الحديثة، حيث القانون هو الترحال المستمر إلى مناطق الكلأ والماء. والعلاقة الرومانسية، بأبعادها العاطفية والوجدانية لا ترتبط بالمكان، ولكن بغيمة المطر وجدول الماء، حيث يوجدان. إنها تتغنى بعلاقة الفرد بالخيمة ووسيلة النقل، وكلتاهما متحركة. وتتجلى الفروسية بالدفاع عن الحبيبة وعن مضارب الخيام، حيث يختزل مفهوم الوطن.
وحتى ما حواه الأدب من بكاء على الأطلال، فإن البكائيات، لا تتجه إلى مضارب الخيام، بل إلى الأهل، أو الحبيبة التي رحلت بمضارب خيامها عن المكان. ومن هنا نجد التغني في الفولكلور والأدب في تلك المجتمعات يتجه مباشرة إلى الناس والأشياء المتحركة وليس إلى الأوطان.
تنعدم في هذه البنية المجتمعية، الحاجة لفكرة الوطن. إن حضور مفهوم الوطن يعني الاستقرار، وتشذيب العصبية، وترسخ فكرة الانتماء للأرض، تتحدد ملامحها وطبيعتها وخصائصها وحدودها، وذلك ما لا ينسجم مع طبيعة مشروع هذه الجماعات، المستند على عقيدة الهجرة المستمرة، والترحال الدائم. وهو موقف يأتي منسجماً مع مورّثات سكنت في النفس منذ عهود سحيقة، وأضيف إليها أجر الدنيا والآخرة.
الأفكار في بنية هذه الجماعات لا تحتمل النسبية، كونها في مناهجها وبرامجها مطلقة، ترفض الشك والأسئلة، بما يجعلها باستمرار على الجادة النقيضة لعلم السياسة. ولذلك يسود التكفير بدلاً من التفكير.
فكرة المواطنة المعاصرة تستند على الدولة المدنية، التي هي نتاج التطور التاريخي، الذي ارتبط بمرحلة الرومانسية، التي هيأت السبل، لاندلاع الثورة الصناعية. وهي جزء من سيرورة عصر الأنوار، وأساسها التبشير بنشوء دول حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق، وتنطلق من قيم وضوابط في الحكم والسيادة. وتبلور مفهوم الدولة المدنية، عبر إسهامات متعددة من مصادر مختلفة في العلوم الاجتماعية.
انطلق المفكرون والفلاسفة الذين أسهموا في صياغة فكرة الدولة المدنية، من اعتقاد راسخ بأن الطبيعة تقوم على الفوضى وطغيان الأقوى، حيث تسود نزعات القوة والسيطرة والغضب، ويغيب التسامح والتعاون من أجل العيش المشترك. إن تأسيس الدولة المدنية، هو الذي يتكفل بلجم نزعات القوة والسيطرة، ويصد البشر عن الاعتداء على بعضهم. وشرط تحقق ذلك، هو تدشين مؤسسات سياسية وقانونية، بعيدة عن هيمنة النزعات الفردية أو الفئوية. ويكون من المهام التي تضطلع بها، تنظيم الحياة العامة وحماية الملكية الخاصة، وشؤون التعاقد، وأن يطبق القانون على جميع الناس بغض النظر عن مواقعهم وانتماءاتهم.
والأهم في الدولة المدنية، هو تمثيلها لإرادة المجتمع، كونها تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة. إن ذلك يعني أنها دولة قانون، فهي اتحاد أفراد يخضعون لنظام من القوانين، ويعيشون في مجتمع واحد. مع وجود قضاء مستقل يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل، حيث لا تنتهك حقوق أي من أفراده، من قبل أيٍّ كان. ويتحقق العدل من خلال وجود سلطة عليا، تحمي حقوق المجتمع، أفراداً وجماعات، وتمنع أيّ نوع من الانتهاكات أو التعديات عليها.
تستند هذه الدولة على شبكة من العلاقات، قوامها التسامح وقبول الآخر والمساواة بالحقوق والواجبات. وتؤسس هذه القيم لثقافة مبدأ الاتفاق، المستندة على احترام القانون، وعلى السلام والعيش المشترك، ورفض العنف، وعلى القيم الإنسانية العامة، ورفض النزعات المتطرفة.
ولا تستقيم الدولة المدنية إلا بشيوع مبدأ المواطنة، حيث يُعرف الفرد بانتمائه للوطن، وليس بمهنته أو معتقده أو منطقته أو بماله أو سلطته. وإنما يُعرف قانونياً واجتماعياً بأنه مواطن، له حقوق وعليه واجبات، يتساوى فيها مع جميع المواطنين.
في الدولة المدنية، يؤسس القانون قيمة العدل، والثقافة قيمة السلام الاجتماعي، والمواطنة قيمة المساواة. سيظل مفهوم المواطنة والدولة الحديثة، مغيباً في فكر الجماعات المتطرفة، ما لم تحدث نقلة نوعية في بنيتها ومنطلقاتها، بحيث تتمكن من تجاوز غربتها التاريخية.
إن ذلك يستدعي تغييراً في المرتكزات الثقافية والفكرية التي تستند عليها هذه التيارات، وقبول فكرة التعدد والتسامح والتعايش السلمي مع الآخر، بما يعزز مفهوم الشراكة والتوافق الوطني. وهو وحده سبيلها، إذا أرادت التخلص من غربتها، والعيش في القلب من أوطانها وليس على هوامش التاريخ.








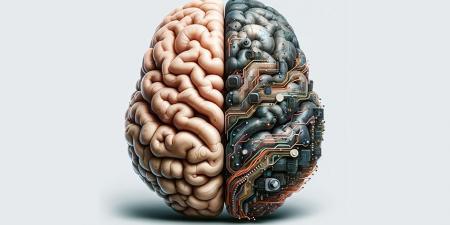

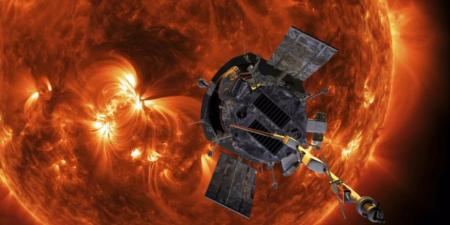


0 تعليق