يختلف تفاعُل الثّقافة العربيّة مع محيط الثّقافات التي اتّصلت بها، في العصر الحديث، عمّا كانَهُ تفاعُلها مع الثّقافات الإنسانيّة المحيطة في القديم، أعني في عهدها الكلاسيكيّ المضيء والممتدّ بين القرن التّاسع للميلاد (الثّاني للهجرة) ونهاية القرن الثّاني عشر (السّادس للهجرة). تبادَلَتِ الأثرَ في القديم مع ثقافات كبرى (يونانيّة، هنديّة، فارسيّة...)، وهي في لحظة صعودٍ تاريخيّ وحضاريّ كبير، محمولة على شعورٍ طافحٍ بالثّقة بالذّات وبالقدرة على ممارسة فِعْل التّثاقُف على نحوٍ من النِّدِيّة يقيها مغبّةَ الاتّباع السّلبيّ لتيّارات الآخَر الثّقافيّة الوافدة من خارج. أمّا في عهدها الحديث، بدءاً من مطالع القرن التّاسع عشر، فاختلف الأمر عن ذي قبل، حيث كانت خارجةً - لتوِّها- منهكَةً من زمنٍ من الرّكود مظلمٍ أتى عليها لِمَا يزيد عن سبعمئة عام وبالتّالي، ما كان لتأثيرها في الثّقافة الحديثة أن يوازن تأثُّرها بها وانشدادَ قسمٍ من نخبها ومنتجيها إليها.
يَستجرّ واقعُ الاختلاف في التّفاعل الثّقافيّ بين تَيْنك اللّحظتين التّاريخيَّتين اختلافاً في النّتائج المتولّدة منهما، فبينما كان يسع ثقافة العرب القدامى أن تُحسن استضمار الوافد الثّقافيّ إليها فتُصيِّرهُ جزءاً من نسيجها (بما في ذلك تيارات الفكر المحافِظة فيها التي وجَدتْ نفسَها واقعةً تحت سحر المنطق الأرسطيّ، مثلاً، أو التّصوّف الهنديّ والمسيحيّ، بل والتّراث الهلنستيّ بالجملة)، ما كان يسع ثقافةَ العرب المحدَثين والمعاصرين - في المقابل - أن تفعل الشّيءَ نفسَه مع الثّقافة الغربيّة الوافدة من دون أن يتولّد من ذلك انشقاقٌ كبيرٌ في داخلها تنشطر به قواها إلى فسطاطين متقابليْن (أهل الأصالة وأهل الحداثة)، ويهتزّ به توازنُها الذّاتيّ بحيث تشهد على صراعٍ داخليّ فيها (بين الفريقيْن) تنهار فيه قواعد الحوار والمناظرَة ويتحوّل إلى ما يشبه الحرب الأهليّة الثّقافيّة!
وهكذا فالذين عالَنوا الثّقافةَ الغربيّة الوافدة رفضاً جهيراً وشنّعوا عليها، وقَدَحوا في مَن أخذ ولو ببعضٍ من قِيَمها من الكتّاب العرب والمسلمين، لم يفعلوا ما فعلَه أسلافُهم من غُنْمِ بعضٍ من مكتسبات الثّقافات الواحدة قصد إغناء منظومتهم، أو حتّى قصد مواجهتها بأسلحتها (مثلما فعل أبو حامد الغزالي، مثلاً، مع الفلسفة والفلاسفة). لقد استطابوا العيش بذهنيّةٍ تقليديّة قديمة في عصرٍ جديدٍ يمور بالتّغيير، واستمرأوا الانكفاء إلى منظومات الأقدمين المحافظين يردّدونها بوصفها العِلْمَ الحقّ مُولِّين أدبارهم لثورات المعرفة المعاصرة، متصرّفين معها وكأنّها زوبعةٌ في فنجان.
أمّا الذين انفتحوا على الثّقافة الأوروبيّة الوافدة، وكان منهم كتّاب إسلاميّون مصلحون، فما كان انفتاحُهم إيجابيّاً، دائماً، ولا انتهى إلى حوارٍ ثقافيّ حقيقيّ مع الثّقافة الحديثة، بل كان الغالبُ عليه التّوزُّع بين مسلكيْن: مسْلك الانفتاح الانتقائيّ الذي يأخذ من الوافد بمقدارٍ، وغالباً من طريق البَتْر والنّزْع لعناصِرَ بعينها من غير منظومتها!، ومسْلك الانفتاح المتماهي الذي تَمَّحي فيه المسافةُ - أو هي تكاد أن تَمّحي - بين المنتَهِل من الثّقافة العربيّة والمُنْتَهَل من الثّقافة الغربيّة، فيصير الأوّلُ نسخةً كربونيّة من الثّاني: مردِّداً ما يقوله، شارحاً ومختصِراً!
مثّلتِ الإصلاحيّةُ الإسلاميّة ذلك الانفتاحَ الانتقائيّ. وهي إذا كانت قد شذّت، فعلاً، عن تقليدٍ درجَ عليه الكتّاب الإسلاميّون هو الطّعنُ على الفكر الأوروبيّ الحديث وحسبانُه مبْعثَ هدمٍ للهويّة والموروث، فمالَت إلى أن ترى فيه ما يستحقّ الاقتباس والانتهال، إلاّ أنّها تفادت أن تتعامل مع الوافد بوصفه منظومةً ثقافيّة متكاملة واختارت، بدلاً من ذلك، أن تَسْتَلّ منه ما عَنَّ لها اسْتلالُه من الأبعاض المنتَزَعة من سياقاتها، الأمر الذي نَجَم منه ميلادُ خطابٍ فكريّ مزدحِم بتوفيقيّات عسيرة بين نظامٍ من المعارف وآخر.
أمّا الانفتاح المتماهي فمثّلتْهُ تيّاراتٌ من الحداثة تميّزت عن غيرها بالميْل الصّريح إلى التّأوْرُب (والتّغربُن)، وإلى التّماهي مع ثقافة الأوروبيّ واستنساخِها وإعادةِ تدويرها في المكتوبات. ومع أنّ هذه التّيّارات تحاشتِ السّقوط في ما سقطت فيه الإصلاحيّةُ من انتقائيّةٍ وابتسار، إلاّ أنّها لم تمنع نفسَها من السُّقوط في ما هو أسوأ: الغربة عن واقعها الاجتماعيّ والتّاريخيّ وبالتّالي، استسهال تحويل الثّقافة العربيّة إلى مجرَّدِ مريدٍ يتلقّى معارف شيخه الغربيّ!
كان على فكرة الحداثة أن تَنْضَج أكثر ويَقِرَّ لها الوجودُ والانتظام، في الثّقافة العربيّة المعاصرة، لكي تخطوَ هذه الثّقافة خطوات ناجحةً نحو إِصابة جملةٍ من الأهداف أَظْهرُها، في ما يعنينا، ثلاثة: التّحرُّر من نزعة الانتخاب والانتقاء من طريق التّعرّف إلى الثّقافة الغربيّة في منظوميّتها، الانفتاح النّقديّ على الوافد الغربيّ وتحصين الذّات من كلّ ميْلٍ انبهاريّ، وإقامة الميْز فيه بين الإنسانيّ والمحليّ، المعرفيّ والإيديولوجيّ، ثمّ إحسان المعرفة بالموروث الثّقافيّ (العربيّ- الإسلاميّ)، وإقامة العلاقة به على مقتضًى نقديّ من دون السّقوط في نظرتيْن سلبيّتين إليه: تحقيريّة وتبجيليّة.
وليس من شكٍّ في أنّ هذه المنجَزات المعرفيّة والنّقديّة - ومن هذا الموقع الفكريّ النّقديّ بالذّات - أهَّلتِ الثّقافة العربيّة المعاصرة لأن تخوض تجربةَ تثاقُفٍ ناجحة من موقعٍ نِدِّيّ. أمّا في الطّرف الثّقافيّ الإسلاميّ المقابِل فما قُيِّض للوعي الإسلاميّ المعاصر أن يرث مكتسبات الإصلاحيّة الإسلاميّة ويبْنيَ عليها، بل تراجع عنها - بعد اضمحلالها وزوالها - إلى وعيٍ انكفائيّ إحيائيّ متشرنق على الذّات ومعادٍ للتّقدّم.
[email protected]












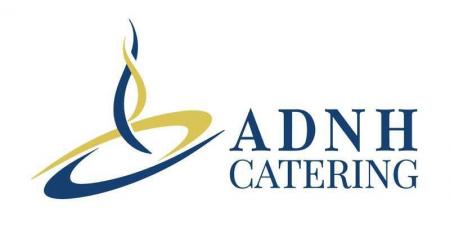




0 تعليق